د
ابدأ بنفسك أولاً!
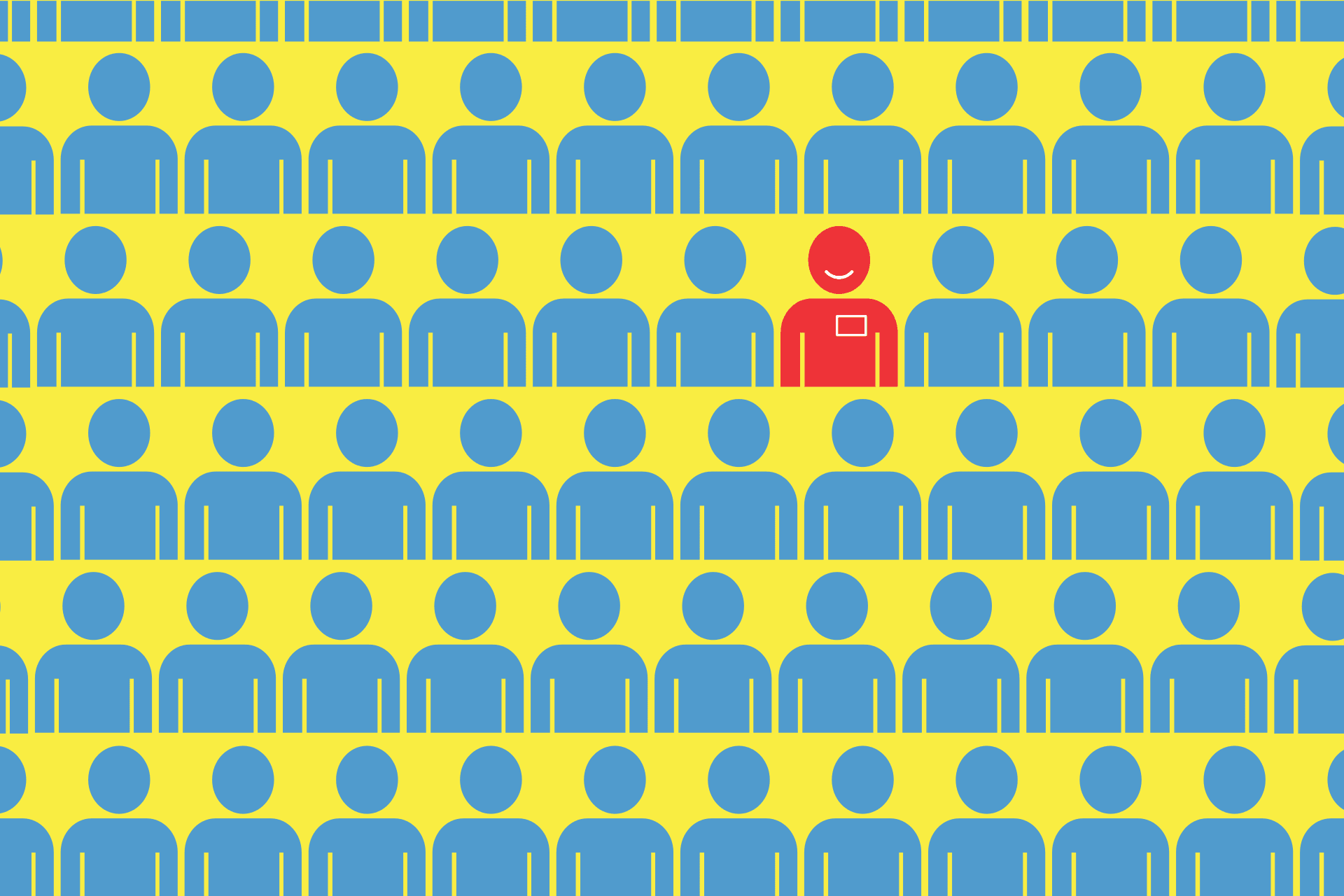
كم عانقت الأماني، وكم قبلت الكلمات الخارجة من فمي على سبيل الدعاء وطلب التغيير، لعلها تتخذ من قبلي ذكرى تحفر بين ثناياها وجسرًا يدلها ويقودها نحوي محملةً بإجابة إلهية على طلباتي ورغباتي الكثيرة، بل كم تعلقت وتمسكت بأحلام لا تراودني إلا بعد كل انتكاسة ويأس يتلبسني. أحلامٌ وردية جميلة، تعبق برائحة عطرية أخَّاذة، تتخللها رائحة الياسمين – الذي ارتبط عندي بذكرى ما عدت أذكرها، ولا أعلم سبب ارتباطها به -. مبان شاهقة وجنان كثيرة تصطف على مد البصر، حتى لا تكاد ترى نهايةً لامتدادها، لا تفصل بينها غير صفوف الياسمين. أحلام أكون فيها المتحكم والمسيطر، أكون فيها ذلك الإنسان النقي البعيد عن الإثم والنواقص، لا أحكم إلا بالعدل، ولا أنطق بغير الحق، الرحمة خلقي، والصفح عن المخطئ إحدى خصالي الحميدة. لا بغض وكره في قلبي، ولا نميمة وإثم يمتطي لساني. فهل أنا إنسان حقًا؟!!
تدوم الأحلام طويلًا، حتى تكاد نفسي تغرق في النقاء غافلةً عن واقعها وفسادها، متناسيةً أنها روح زرعت زرعًا في صنم يحيا بوجودها ويصير جيفةً تتغذى عليها الديدان والحشرات دونها. يؤمن يومًا ويكفر شهرًا. يظن أن شريط حياته في نهر الخلود نقع وغسل، ظن السوء بضعفه وواقع فناء روحه وجسده. يعلل الخطأ بطول الأمد وقرب الفرج، يؤمن بتوبة قريبة لكنها بعيدة، لا حدود لأحلامه وأمانيه لكنها تبقى وليدة الدعاء حبيسة الأماني والرجاء…
ولكنَّ – وكم أكره لفظ لكن، أينما حل واتخذ سبيلًا للدلالة على التحول والتغيير – الطرقات المتتالية التي لا تنتهي إلا بانكسار قشرة دماغي وانفجار أعضائي ألمًا، وانتحار نفسي هربًا من انفصام وانخذال ويأس لا مناص للهرب منه. يدفعني للإجابة، وفتح النوافذ والأبواب سامحًا للطارق بالنفاذ نحو خفايا نفسي، كاشفًا أشد مخاوفي وأقساها. مرددًا بصوته الثخين الغليظ المشبع ببحة غريبة تخرق طبلة أذني. كأن صدى صراخي وألمي المتكرر كل ليلة لا يخرقها ويمزق أغشيتها، ولا يكفي لإفنائها!!
مرددًا: ” كفى أحلامًا، كفى!! “.
ينتزع بطرقاته ما بقي من أشلاء روحي داخل جسدي الخاوي، يجمعها، يحيطها بذراعيه، يضغطها ليعيدها نفسًا وكيانًا واحدًا، لكنها ستبقى ناقصةً…ثم يلقيها في جسدي، لتبعث فيه حياةً وأملًا لا تملكه. فكيف لفاقد الشيء أن يعطيه؟
يتصبب العرق مني، ويصرخ رأسي ألمًا، كلما أفقت من غيبوبة المثالية والحلم وعدت لواقع ضعفي ونقصي…وكلما استثارت الآية الكريمة شعورًا داخلي، شعورًا غريبًا لا عهد لي به، شعورًا يشابه الوقوف خلف القضبان في محكمة يقضي فيها القاضي بلزوم القصاص مني، أنا الإنسان الآثم. يقضي بموتي في غياهب ضعفي وسكوني…
قال الخالق عز وجل: ” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “.
مما دفعني للبحث عن تفسير تلك الآية التي تستثير في نفسي كل ذلك وتحل محلًا عظيمًا عندي، لعلي بمعرفة حقيقتها أملك حريتي من عذاب مقيم يكبل النفس والجسد. فوجدتها نصيحةً وحكمًا بالبراءة لنفسي. وجدتها مصباحًا ينير لي طريقًا مظلمًا خضت فيه دون علم، فالله خالقنا وبارئنا والعالم بكل شيء، يحيط بما نسر ونعلن، خلقنا وكرمنا ورفع قدرنا بين خلقه سبحانه وتعالى، سخر لنا كل ما يعيننا على أداء غاية خلقنا. ومن ذلك قاعدة نافذة إلى يوم الدين، إن أردت أن تغير حالك فعليك بالبدء بنفسك. أقتل مواطن الذل والكره والإثم فيها، وأحرق غاياتها وكبل شهواتها، واعمل؛ كي تنال صلاح الحال وراحة البال.
فكم أعجب لمن يخلق ويشيد بنيانًا عظيمًا، ويضفي عليه ألوانًا تنعش روح المرء وتجذبه نحوه، مالئًا ساحاته بأحلى الزهور وأعبقها رائحةً وأكثرها تأثيرًا. وقلبه من الحقد والبغض خلق، لا ترى مبسمه ودماثة خلقه إلا إذا لمعت الدنانير أمام عينيه وسمع صوت ارتطامها ببطانة جيبه.
يظن ظنًا – لا سبيل للتيقن منه – أنه محى وستر فساد نفسه، وجشعها بجمال ونظافة قالبها. يرتدي أجمل وأثمن الثياب ويأكل مما تطيب له وتهواه النفس، ظانًا أن ذلك يغسل وسخ وقتامة روحه…
ألا يعلم أن ما خارجنا انعكاس لما داخلنا، وأن بنيانًا أساسه الضعف والفساد لن يكتب له الصمود. ألا يعلم أن قلبًا نقيًا تقيًا تغلفه ثياب رثة قديمة، خير من قلب بيع للشيطان يغلفه كيفما شاء بأحلى وأثمن الأثواب.
وكم أبغض ذلك الذي ينفق عشرات الساعات، يدعوا ويرجوا، دون أن يقرن دعاءه بالسعي والعمل لتحقيقه. كأن صلاح نفسه وسعادته معلقان في السماء في انتظار دام طويلًا، ينتظران وصول دعواته ليسقطا مع قطرات الغيث…
تلك وقفة مقتضبة مع نفسي ومع الآية الكريمة. وقد لا أكون أول من يسلط الضوء على هذه القضية، لكنني أرجو أن أكون آخر من يناقشها ويعايش ويلاتها.